سيكولوجيا التلقّي: خياراتُ الجمهور وآفاقُ الدائرة
محمد جميل خضر 3 ديسمبر 2022
اجتماع
الجماهير تقتحم سجن الباستيل
شارك هذا المقال
حجم الخط
الهجوم المُنظّم، وَحتى الفوضويّ (الاندفاع الأرْعن نحو المستطيل الأخضر لرجلٍ يرتدي زيًّا بعينِه ويحمل رايةً بِعينها)، الذي واجهته الشقيقةُ قطر خلال تحضيراتِها التنظيمية لِنهائيات كأس العالم 2022، وصولًا إلى الأيام الأخيرة قُبيل انطلاق المونديال، وَحتى بعد انطلاقه، وَربما بعد انتهائِه، يفرضُ على أصحاب الاختصاص، ولستُ منهم، بَحْثَ الدّوافع الدفينةِ لكلِّ هذا الهجوم، وقراءة المشهد بِأبعاده جميعها، من دون إغفال ما يتعلق منها بِسيكولوجية التلقّي، وَمن ورائها سيْكولوجية الجماهير التي تناولها، قبل 127 عامًا، عالم النفس الفرنسي غوستاف لوبون (1841 ـ 1931)، عبر كتابِه المُهم "سيْكولوجية الجماهير" (1895).
الجماهير، في معظمها، متلقيّةٌ للفعل لا مؤسِّسة له، أو حتى مساهمة فيه. وأما الفعل فهو يمتد على مساحة تجلّيات الوجود جميعها من فن (دراما مسرحية وسينمائية وتلفزيونية، وتشكيل ونحت، وفنون أداء)، وأدب (شعر ونثر)، وتوجيه سياسيٍّ، وخطاب شعبويّ، وحملات دِعائية، وصراعات، وحروب، وسياسات اقتصادية، ومناهج تربوية، أو تعليمية، وصولًا للمعتقدات الدينية والعقائدية، وما يتعلق بتلك المعتقدات والتحزّبات، من كتبٍ مقدسة، وأدبياتٍ، وتنظيراتٍ، ومراسلات.
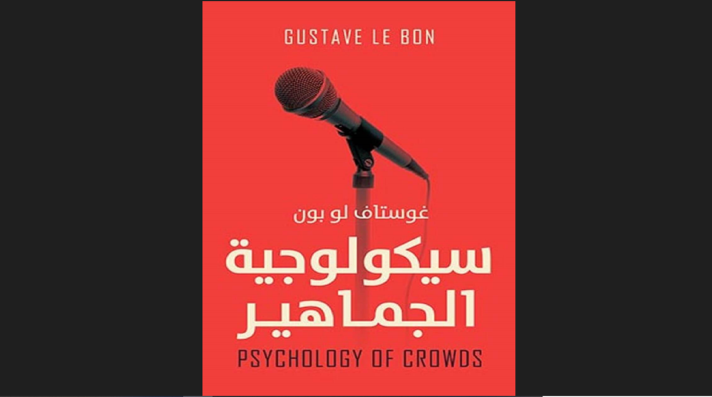
وعلى مرّ تجارب الحضارات، وتقلّبات الدُوَل، صار لهذا التلقّي مواضعاتُه، ومواصفاتُه، وأشكالُه، ودرجاتُه، وطرائقُ التّعبير عنه.
الفَرَدانية الأوروبية (المدّعاة في بعض الأحيان) لم تنجح في تحويل الناس هناك من جماهير قطيعيةٍ (من القطيع) في بعض الأحيان، إلى أفرادٍ أحرارٍ مستقلّين محصّنين بالوعيِ الرشيد والرأيِ السّديد.
وَتلك فردانيةٌ دفع الأوروبي (نقدًا)، وبعد حربيْن كونيّتيْن، ثمنًا باهظًا لِجني بعض ثمارها، ثمنًا بلغ عشرات الملايين من أرواح بَنيه، وما لحق بدولِهِ وكياناتِهِ وعمارتِهِ من دمارٍ ماحِق، وما نتج عنهما من تغيّر جغرافيا القارّة إلى الأبد، وكذلك تبدّل تحالفاتِها، وقيمِها، وتصدّع موروثِها، وغثيانِ ذاكرتِها.
والحالُ كذلك، وفي ظلِّ خصوصيةِ الأقْدار التي قادت أوروبا، والغرب على وجه العموم، إلى ما هي عليه أحوالها، وأحواله اليوم، وخصوصية الصراعات التي جرى خوضُها فوق أرضها، فإن منطق الأشياء يقول إن آخر ما ينبغي لها (شعوبًا وحكومات) أن تفكّر فيه هو تصدير تجربتها إلى غيرها!
ألم تقدّم القارّة العجوز أرواح زهاء 76 مليون من أبنائها (60 مليونًا في الحرب العالمية الثانية، و16 مليونًا في الحرب الأولى)، لِتقول لا لأيِّ من أراد أن يفرض عليها منطقًا من دون غيره بالقوة، أو بِالبطش، أو بِالخطب الرنّانة، أو بِالدافعية القومية العمياء؟
لم تقبل أوروبا نازيّة هتلر، ولا فاشيّة موسوليني، ولا هويّة الإمبراطورية العثمانية، ولا استبداديّة فرانكو، ولا اشتراكيّة روسيا، ولا.. ولا، بالتالي، فإنّ الأولى، وهي المحقّة بِرفض مختلف ما تقدّم، الممجّدة، والمقدّرة، لأنها دفعت كل هذه الأكْلاف في سبيل دفاعِها عن (تنويرِها)، أن لا تندفع، لا جماهيريًّا ولا فرديًّا، نحو فرض أيِّ منطقٍ، مهما تخيّلت صوابيّته، أو رأت أسبقيّته، على غيرِها.
كيف تكوّن الجمهور؟
في سياق دلالاتِها العادية، غير المركّبة نفسيًا، ولا المعبّأة أجنداتيًّا، فإن مُفردة الجمهور تعني "تجمعًا لمجموعة، لا على التعيين، من الأفراد، أيًّا تكُن هويّتهم القومية، أو مهنتهم، أو جنسهم، وأيًّا تكُن المصادفة التي جمعتهم" (لوبون، السيكولوجيا، ص 53).
وفي البعد الاصطلاحي، ومن وجهة النظر النفسية، وليس اللغوية، تتبنّى الكتلة الجماهيرية "مواقف قد لا تعبّر عن كلٍّ واحد من هذه الكتلة منفردًا. ومن المرجح أن تشكّل كتلةٌ بشريةٌ ما، خصائص جديدة، مختلفة، تمامًا، عن خصائص كلّ فرد من أفراد هذه الكتلة على حِدَة".
وفي الأصل، تراكمت فكرة تعريف الجمهور في سياق وصف الناس الذين يُقبلون على عرضٍ دراميٍّ، أو أيّ استعراضٍ عام يستقطب عددًا من الناس، ويتّصفُ ما أصبح يُعرف بِالجمهور منذ الزّمن اليونانيّ والإغريقيّ، ومن بعدهما الرومانيّ، بِسماتٍ عامّة، تراكمت على مدى الأزمان، وأفرادُه معروفونَ بِذواتهم، ومحدّدون في الزّمان والمكان. وهم، عادة، سكّان مدينة، أو قرية واحدة، يجتمعون بين الفيْنة والأُخرى، وعلى اختلافِ الظروف والمناسبات، ليتحوّلوا إلى جمهورِ عبادةٍ في مكان العبادة، وإلى جمهور في المسرح، أو في السوق، ولاحقًا، إلى جمهورٍ في الملعب. وكان الانضمام إلى هذا الجمهور يَجري، بحكم العادة، وفقًا لِلمراتب والمراكز الاجتماعية، وتشرف عليه سلطة دينية، أو روحية، أو إدارية، حيث كان يجلس الملك، أو سيّد القبيلة (في المجتمعات القَبَلية) في المقدمة، ثم تأتي حاشيته، ثم النبلاء والأعيان وكبار القوم، ويأتي عامّة الناس من بعدِ كل هؤلاء. وقد أضفت السلطات، في كلِّ زمان ومكان، على الجمهور طابعًا مؤسسيًّا توحّده سلوكياتٌ جماعيةٌ معيّنة، فالحاكم يحتاج إلى محكومين، ودُور العبادة تحتاج إلى عابِدين، والسوق تحتاج إلى مُشترين، والملعب لا يحتاج إلى لاعبين فقط، ولا إلى حكّام فقط، ولا إلى نشيديْن وطنييْن فقط، ولا إلى أعلام ورايات فقط، ولا إلى مسوّقين فقط، ولا إلى قوانين واتحادات فقط، ولكنه يحتاج، قبل كل هذا وذاك، وخلاله، وبعده، إلى جمهور.
على مرّ السنين والقرون، وتبدّل الحضارات، تطوّر مفهوم الجمهور، وأسهم اختراع الطباعة في القرن الخامس عشر الميلادي، على يد الألماني يوهان غوتنبرغ (1398 ـ 1468)، بِظهور نوعٍ آخر من الجمهور (جمهور القراءة). ومع صدور الصحف، صار يمكن الحديث عن "رأيٍ عام" يمكن توجيهه، أو استنباط توجهاته، أو مراقبة تحرّكاته. ليس هذا فقط، بل بات في مقدورِ السلطة الحاكمة التمييز بين نوعيْن كبيريْن يقعان ضمن نطاق سلطاتها: الخاصّة والعامّة، النُّخبة والعَوام، البرْجوازية المتسلّقة والبُروليتاريا الكادِحة، على اختلاف المسمّيات ومرجعيات هذه المسمّيات.
بعد الطباعة، جاء الدور على الإذاعة، ومن بعدها التلفزيون، وبينهما السينما، في نقلِ الجمهور من محليّة بقعتِهِ الجغرافيّة، إلى عالميّةِ تجمهرِهِ حول قيمةٍ، أو فكرةٍ، أو ماركةٍ، أو نادٍ، أو نجمٍ، أو زعيمٍ، أو استقطابٍ دينيٍّ، أو عنصريٍّ، أو إثنيٍّ، أو أيّ دافعٍ شعبويّ.
الفضاءُ الأزرقُ الذي تجلّى بوصفِه ذروةَ ثورةِ الاتّصالات، وَتكنولوجيا المعلومات، فاقَ كلّ ما سبقه، عند الحديثِ عن فرصِ الاستقطابِ، وممكناتِ جمعِ الأشتاتِ حولَ ما يجمعهم، وباتت مواقعُ التواصل الاجتماعيّ أخطرَ وسائلِ تحشيدِ الجَماهير، وأسهلَ من يُشيع (البروباغندا)، ويروّع الحقيقة، ويطوّع العقول، ويضلّل البوصلات.
حتمًا، لن تفي العُجالةُ أعلاه بتدبيجِ إجابةٍ شافيةٍ عن السؤال أعلاه: كيف تكوّن الجمهور؟ ولكنها قد تسهم في التأسيسِ لتصوّر ممكنٍ حول كاريزماتِ بناءِ جمهورٍ ما، وحول كيف كيّفت السُّلطةُ مَن حوْلها، وَجعلت من الكُتل المتشرذمةِ في مناطقِ نفوذِها قيمةً مضافةً لها، لا ضدّها.
كان لا بدّ، إذًا، من تَكوِّن الجمهور. كان لا بدّ من صيحات تشجيع، أو استهجان، أو تأييد، أو تراتيل عِبادة. كان لا بدّ من واضِعي (لايكات)، أو مروّجي إشاعات، أو مبتكري هُتافات. هل الجمهور، بِالتالي، جميعُه، بِجميع مكوّناته، وعلى اختلافِ تفاصيلِه المعرفيّة والخَلْقية والخُلُقيّة، يحمل الأبواقَ ويزمّر، أو يحمل الطبول ويطبّل؟ ليس شرطًا، فحتّى الثورات الصالحة تحتاجُ إلى جمهور، والأفكارُ النيّرة تحتاجُ إلى جمهور، والوعيُّ الجمعيُّ يحتاجُ إلى جمهور. كتلٌ لا بدّ منها، ولكن، وَيا لِحسرتي، ما أسرعَ استقطابَها، وما أهشّ وعيهَا، وما أقسى انقضاضَها حينما، بوحشيةٍ قطيعيةٍ مسلوبةَ التعقّل، تنقضُ لا تعرفُ لماذا، ولا كيف، ولا تعدّ للعَشرة، ولدينا، هُنا، في قصة قتلِ المدرّسة الأفغانيةِ فرخندة ملكيزاده الحاصلةِ على درجةٍ أكاديميةٍ في علوم الشريعة، المرتديةِ للحجاب، أسوأ مثالٍ على القطيعيةِ العمياء.
الحشود التي تحوّلت إلى جمهورٍ مسيّرٍ مُنقاد قتلت فرخنده (27 عامًا) بِطريقةٍ بشِعة يصعب تخيّلها، أو حتى الخوض في تفاصيلها، من دون أن يتحقق الذين شاركوا في عملية القتل الجماعيّ الهائج من التهمة التي وجّهها لها (مُلّا) يتاجِر بالدّين. والقصة أن الشابّة المتديّنة كانت حاجَجت مسترزقًا باسم الدين يبيع السّحر لأحد المساجد في كابول، وأخبرته أن ما يفعله لا علاقة له بِالدين، لا من قريب ولا من بعيد، فما كان منه، وَقد أُسقط في يده أمام قوّة حجّتها، وَسلامة منطقها، إلا أن اتّهمها أنها (دنّست) القرآن وأحرقته، ورغم أنها أجابته وقالت له: "أنا مسلمةٌ، والمسلمون لا يحرقون القرآن"، ولكن هيهات، فقد فات الأوان، ووقعَ فأسُ الغوغاءِ والجهلِ في رأسِ العقل، وخلال دقائق معدودة، تدرّج الاعتداءُ الأعمى، من الركل والرفس والضرب بالخشب والحديد، والرجم بالحجارة، وصولًا إلى السحل بواسطة سيارة لِمسافة 300 متر، ثم إحراق الجسد، وفي تلك المرحلة بدأ (الجمهور) التبرّع بملابسه لِتبقى نارُ حرقِها متّقدة، فملابِسها كانت غارقةً بِالدم، ولا تُعين النارَ في عملِها!
مقابل هذا المشهد المروّع، مما لا شكّ فيه، أن النيوزلنديّ الذي (تسلّى) بقتلِ أكثر من 50 مسلمًا وهم ركّعًا سُجود، وجرح برشاشه الأوتوماتيكيّ، تقريبًا، مثلَهم، يجسّد غوغائية جمهورٍ من نوعٍ آخر. جمهورُ برينتون تارانت (اسم الإرهابيّ الذي ارتكب جريمة نيوزيلندا)، كان يتابعه بلهفةٍ وحماسةٍ على الهواء مباشرةً! (تارانت كان يضع كاميرا عند فوّهة البندقية)، وحظيَ بتأييدٍ لعلّ الشعبويّ ترامب لم ينل مثله! صحيحٌ أن الاستنكار كان كاسحًا، ولكن الخشية، كلّ الخشية، هي ممّن يستنكرون بِألسنتهم، ويؤيدون بِأعماق الكراهية المزروعة، كالطّاعون، في ضلوع تكوّنهم الجمعيّ الذي تراكمت مفرداته على مرّ عصورٍ سحيقةٍ من بثّ الضغينة، وتجييشِ الحُشود، وغسلِ عقول الأتْباع، وترويضِ العامّة (العَوام). أليس العَوام المطلوبين لِعدالة المحاكم، هم من أرسلهم الغرب إبّان الحملات الصليبيةِ المدّعية أن حربَها مقدّسة، ورسالتَها محصّنة، تسعى لِإنصافِ العهديْن، القديم والجديد؟
على وجه العموم، فإن الانضواء في الحشدِ الجماهيريّ له مفعولُ التنويمِ المغناطسييّ، المُفضي إلى تصرّفات، وردودِ أفعالٍ، وأشكالِ تلقٍ غيرَ واعِيَة. وها هو لوبون يقول: "الجماهيرُ غيْر ميّالة، عادةً، للتأمّل، وغيْر مؤهّلة لِلمحاكمة العقليّة" (صفحة 45).
يبْدو أنّ الفردَ المُنضوي بيْن الجمهور يتولّد لديهِ شعورٌ بِالقوة، ما يجْعل اندفاعَه نحوَ بعضِ الأفعالِ الغرائزيّةِ ممكنًا. هذا الاندفاع، أو الانصياع، كما يسمّيه لوبون، يحدُث، في كثيرٍ من الأحيان، بشكلٍ اختياريّ، بقوّة التّباهي النّاجمة عن قوّةِ الحَشْد، وفي ظلِّ غيابِ الإحْساس بالمسؤوليّةِ الفرديّةِ التي تَغيب، تمامًا، بِفعل ضغط الكُتلة (الجماهيرية) ومُغْرياتها. وممّا لا شكّ فيه أن العَدوى العقليّة مِن جِهة، والتّحريض من جهةٍ أُخرى، يلْعبان دورًا محوريّا في ظهورِ الصّفات الجماهيرية العامة.
كلُّ هذا يقودُنا إلى ما يمْكن تسميتَه: "عِلْمُ نَفْسِ القَطيع"، حيث غِياب الفِعل الواعي، وتسيّد الانْخراط المسيّر غيرِ المُدْرِك، وَلا المَسْؤول (القطيعيّ بشكلٍ، أوْ بِآخر).
هذا ما يتلقّاه الجمهور، ولكن، كيف يتحقّق هذا التلقّي؟ وهل هو واحدٌ في مختلفِ الحالات؟ وما هي العوامل التي تؤثّر في شكل التلقّي وَمحتواه؟ وفي مردودِه وطرائقِ التّعبير عنه؟
مساراتُ التلقّي
التلقّي ليس مفردةً حديثةُ العهد، فها هو القرآن يقول للنبيّ محمد: {وإنك لَتُلقّى القُرآنَ مِنْ لَدُن حَكيمٍ عَليم} (سورة النمل، آية: 6). وَفي آيةٍ أُخرى: {فتلقّى آدَمُ مِنْ ربِّهِ كلماتٍ فَتابَ عليه، إنّه هُوَ التوّاب الرَّحيم} (سورة البقرة، آية: 37).
على وجه العموم، فإن معنى التلقّي في مداه اللغوي، وكما ورد عند ابن منظور في "لسان العرب"، أي تلقّاه/ استقبله، وفُلانٌ يتلقّى فُلانًا، أيْ يستقبلُه.
والتلقّي، اصطلاحًا، هو "الفعل الذي يمارسه الفردُ كإنسانٍ لهُ مكوناتهُ النفسيّةِ والذهنيّةِ والانفعاليّةِ والاجتماعيّةِ، لِتفسيرِ ما يُقدَّم له. وهو فعلٌ يتضمّن: الإحساسَ والذكاءَ والإدراكَ وبناءَ المعنى" (مخلوف بوكروح، 2006).
وهُو "الاتّجاهاتُ والنّشاطاتُ التي يُظهرها المتلقّي خلال تلقّيه لِرسائل الأعمالِ الأدبيّةِ والفنيّةِ والإعلاميّة. كما يمثّل، أيضًا، الطريقة، أو الأسْلوب الذي يسْتخدم فيه المتلقّي المعلوماتِ التي يتلقّاها من الخطاب مهما كانت طبيعته" (نظرية التلقي وأطروحاته، د. مرزوق الشريف، مجلّة النص، المجلد السابع، العدد الأول، صفحة 194، سنة 2021).
مع تطوّر العلومِ الإنسانيّة، صار لِلتلقّي نظريات، وآفاق توقّع، خاضَ فيه الباحِثون والدّارسون، وطلاب الدّرجات الأكاديمية، استقصاءً ونبشًا وتعريجًا على أهمِّ المنظّرين فيه. وَمنذ أعلن الفرنسي رولان بارت (1915 ـ 1980) "موت المؤلِّف"، باتت معظم نظريات النقد الأدبي وطروحاته تتجّه نحو المتلقّي. وَنظرية التلقّي مرتبطةٌ، كما بات معلومًا لدى أصحاب الاختصاص، بمرحلة ما بعد الحداثة، أي عندما نزَعت أوروبا نحوَ نقدِ مركزيةِ الذّات. وهي، إلى ذلك، تمثّل "النموذج الجديد الذي يمكن الاستئناسُ به في قراءةِ الأعمال الأدبيّة والفنيّة"، كما يرى الناقد الألماني هانس روبرت جاوس أو هاوس (1921 ـ 1997) في بحثه الذي يحمل عنوان "التغيّر في نموذج الثقافة الأدبيّة". وجاوس، ابْن جامعة كونستانسن الألمانية، هُوَ أحد المنظّرين الروّاد لنظريةِ التلقّي.
لا شك في أن مؤثراتٍ ومحدّدات عديدة (جوّانيّة وبرّانيّة) تلعب دورًا مهمًّا في شكلِ التلقّي، ودرجاتِه، ومردودِه، وَخيارات التفاعل بعد فعل التلقّي. ومن هذه المحدّدات: قيمُ المتلقّي، وعيُه، معتقداتُه، ثقافتُه وسلّةُ معارفِه، محيطُه الجمعيّ، سياسات حكومته، مستواه الاجتماعيّ والاقتصاديّ، وَعوامل أُخرى كثيرة. كلُّ هذا يعيدُنا، مرّةً أُخرى، إلى معضلةِ الجمهور، وَلنا في قضايا تكفيرِ الكتّاب، وتخوينِ المُعارضين، وشيطنةِ المُختلفين، وبثّ الرعب من اللاجئين، وَلصقِ تهمةِ الإرهاب بالملوّنين، والتقْليلِ من شأنِ الآخرين، والاستهتارِ بثقافتِهم، وموروثِهم، ومرجعياتهم الأخلاقيّة والقيميّة، أدلّةٌ دامغةٌ، على انْجرافِ كثيرٍ من ميكانيزْمات التلقّي نحو ردِّ الفعل الجماعيّ المروّض. إن تنميطَ التلقّي غايةٌ كبرى تسعى السُّلطة لِتكريسِها. والسّلطةُ، هُنا، قد تكون دينيةً، أو سياسيةً، أو اقتصاديةً، أو حلفًا عسكريًّا، أو عِرقًا أبيضَ.
آفاق الدائرة
التلقّي جزءٌ من دائرةٍ تتكوّن من: مرسِل، رسالة، متلقٍّ، إضافةٍ إلى رسالةِ ما بعد التلقّي (الرسالة الثانية، باعتبار أن رِسالة المرسِل هي الرسالة الأولى). والآفاق التي تهمّنا من بين باقي زوايا هذا المعين، أو أقطاب هذه الدائرة، هي آفاق الرسالة الثانية، فهي خلاصة كلّ هذا المعادلة الرُباعية المدوّرة. إنها التغذيةُ الراجعةُ التي يَنشدها صاحب الرسالة الأولى. وهي ما تجلس أركان السلطة بِعيونٍ متيقّظةٍ، وآذانٍ مشنّفة، لتتابع، على مدار الساعة، المردودَ من وراءِ بثّ الرسائل التي تودّ من متلقّيها أن يتلقّوها، من دون سِواها، حتى لَتكاد، لو كان ذلك في استطاعتِها، أن تُغلق على رعاياها (جمهورها المفترض وفضاؤُها العام) كل فتحات تسريبِ أي رسائل أخرى غير رسائلها. تود لو تقفل النوافذ، وتخنق كلَّ هواءٍ غير هوائها. فكيف لها أن تروّض الرأي العام، من دون كل هذه الإغلاقات، ومن دون أن تكون قادرة على تحديد ما تسمح له بالمرور، وما تمنعه الاقتراب من فضاء سلطتها؟
(ولن أمنع نفسي، هنا، من الاستشهاد بقصة أن منبر "ضفة ثالثة"، على سبيل المثال، غير متاح في بعض الدول العربية، كثير من الأصدقاء يهاتِفونني مستنجدِين: لم نستطِع فتح رابط الموضوع الذي أكون، مثلًا، قد اقتبستُ منهم خلال كتابتِه، أو طلبتُ رأيهم فيه).
هل يبقى للدائرة المتخيّلة تلك من آفاق، بعد كل هذا الانغلاق؟ ولكن، صدّقوني، هو ليس انغلاقًا شرقيًّا بحتًا. هل فتح الغرب ملف (الهولوكوست)؟ هل يسمح بمجرّد التطرّق إليه؟ أين هم الآن كل الذين حاولوا إعادة تأمّل المحرقة بعد 79 عامًا من حدوثها؟ هل يقبل الغرب إيّاه أيَّ مراجعةٍ علميةٍ نقديةٍ موضوعيةٍ لِهذه الاندفاعةِ الغريبةِ والعَجيبة نحوَ تأييدِ شريحةٍ من دون سِواها، من بيْن باقي كلِّ شرائحِ المُجتمع؟ وأنتم، حتمًا، تعرفون أيَّ شريحةٍ أقصد، تلك التي أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، لمجرّد أن قطر طلبت تأجيل فَجاجتها لِعيون شهرِ رياضةٍ ومحبّةٍ فقط!
لا أحد يريد استهدافَ اختلافاتِ البَشر، ولكن من قال إن من حق المختلفين أن يفرضوا علينا (نحن الأسوياء) أن ننحني لهم عند كل ناصية طريق، خضوعًا لِماكينة إعلام لا تهدأ، وَحملة ضَروس تتضمّن مسلسلات، وأفلامًا (مئات الأفلام صدّقوني فأنا أشاهد فيلميْن يوميًّا على الأقل)، وبرامج، ومنشورات، وملصقات، ومشاريعَ مدْعومة، ورواياتٍ ملْغومة، واستدامةً مزعومة، وألوانًا، وخِططَ عَمَل، وتِكرارًا لا يهدأُ ولا يَمَل؟
"لكم دينكم وليَ دين". وليس من العدل، ولا من المنطق، أنكم تريدونَنا، رغْم أنوفِنا، أن نعبدَ ما تعْبُدون؟
معضلةُ الشّرق
شكّل الشرق منذ أوّل الزمان، وما يزال، حالة عصيًّة على الغرب.
يقول البروفيسور كريج كلوناس، أمين متحف فرويد في لندن، والخبير في الثقافة الصينية، إن الشرق بالنسبة إلى سيغموند فرويد (1856 ـ 1939) ظل يماثل منطقةً مظلمةً وخفيةً في لاوَعيِه، معلّلًا بِكلامه هذا سبب احتفاظ مؤسِّس مدرسة التحليل النفسي، وصاحب نظرية العقل الباطن، بِقطعة أثاثٍ صينية (شاشة صغيرة مصنوعة من اليشْم والخشب المثقوب)، وطلبِهِ من صديقتِهِ ماري بونابرت تهريبها إليه، من دون كل باقي أثاث منزله، عندما فرّ من النازيين إلى لندن، وأراد أن تكون تلك القطعة رفيقة أخريات أيامه، بعيدًا عن وطنه النمسا.
إن حال فرويد هي حال ملايين الأوروبيين، بمن فيهم مئات المستشرقين، الذين قضى بعضهُم أعمارَهم مُحاولين فكّ طلاسم الشرق، فإذا بهم، وفي فوْرةِ استعصائِهِ عليهم، ينصحون باستعمارِه، فهذا فعلٌ أسهلُ من محاولةِ فهم الآخَر وتقبّله!
تقبّلونا بِما نَحْنُ عليه، يرحمكم الله، قبل أنْ تفرِضوا عليْنا تقبّلَكم على علّاتكم.
محمد جميل خضر 3 ديسمبر 2022
اجتماع
الجماهير تقتحم سجن الباستيل
شارك هذا المقال
حجم الخط
الهجوم المُنظّم، وَحتى الفوضويّ (الاندفاع الأرْعن نحو المستطيل الأخضر لرجلٍ يرتدي زيًّا بعينِه ويحمل رايةً بِعينها)، الذي واجهته الشقيقةُ قطر خلال تحضيراتِها التنظيمية لِنهائيات كأس العالم 2022، وصولًا إلى الأيام الأخيرة قُبيل انطلاق المونديال، وَحتى بعد انطلاقه، وَربما بعد انتهائِه، يفرضُ على أصحاب الاختصاص، ولستُ منهم، بَحْثَ الدّوافع الدفينةِ لكلِّ هذا الهجوم، وقراءة المشهد بِأبعاده جميعها، من دون إغفال ما يتعلق منها بِسيكولوجية التلقّي، وَمن ورائها سيْكولوجية الجماهير التي تناولها، قبل 127 عامًا، عالم النفس الفرنسي غوستاف لوبون (1841 ـ 1931)، عبر كتابِه المُهم "سيْكولوجية الجماهير" (1895).
الجماهير، في معظمها، متلقيّةٌ للفعل لا مؤسِّسة له، أو حتى مساهمة فيه. وأما الفعل فهو يمتد على مساحة تجلّيات الوجود جميعها من فن (دراما مسرحية وسينمائية وتلفزيونية، وتشكيل ونحت، وفنون أداء)، وأدب (شعر ونثر)، وتوجيه سياسيٍّ، وخطاب شعبويّ، وحملات دِعائية، وصراعات، وحروب، وسياسات اقتصادية، ومناهج تربوية، أو تعليمية، وصولًا للمعتقدات الدينية والعقائدية، وما يتعلق بتلك المعتقدات والتحزّبات، من كتبٍ مقدسة، وأدبياتٍ، وتنظيراتٍ، ومراسلات.
وعلى مرّ تجارب الحضارات، وتقلّبات الدُوَل، صار لهذا التلقّي مواضعاتُه، ومواصفاتُه، وأشكالُه، ودرجاتُه، وطرائقُ التّعبير عنه.
الفَرَدانية الأوروبية (المدّعاة في بعض الأحيان) لم تنجح في تحويل الناس هناك من جماهير قطيعيةٍ (من القطيع) في بعض الأحيان، إلى أفرادٍ أحرارٍ مستقلّين محصّنين بالوعيِ الرشيد والرأيِ السّديد.
وَتلك فردانيةٌ دفع الأوروبي (نقدًا)، وبعد حربيْن كونيّتيْن، ثمنًا باهظًا لِجني بعض ثمارها، ثمنًا بلغ عشرات الملايين من أرواح بَنيه، وما لحق بدولِهِ وكياناتِهِ وعمارتِهِ من دمارٍ ماحِق، وما نتج عنهما من تغيّر جغرافيا القارّة إلى الأبد، وكذلك تبدّل تحالفاتِها، وقيمِها، وتصدّع موروثِها، وغثيانِ ذاكرتِها.
| "الجماهير، في معظمها، متلقيّةٌ للفعل لا مؤسِّسة له، أو حتى مساهمة فيه" |
والحالُ كذلك، وفي ظلِّ خصوصيةِ الأقْدار التي قادت أوروبا، والغرب على وجه العموم، إلى ما هي عليه أحوالها، وأحواله اليوم، وخصوصية الصراعات التي جرى خوضُها فوق أرضها، فإن منطق الأشياء يقول إن آخر ما ينبغي لها (شعوبًا وحكومات) أن تفكّر فيه هو تصدير تجربتها إلى غيرها!
ألم تقدّم القارّة العجوز أرواح زهاء 76 مليون من أبنائها (60 مليونًا في الحرب العالمية الثانية، و16 مليونًا في الحرب الأولى)، لِتقول لا لأيِّ من أراد أن يفرض عليها منطقًا من دون غيره بالقوة، أو بِالبطش، أو بِالخطب الرنّانة، أو بِالدافعية القومية العمياء؟
لم تقبل أوروبا نازيّة هتلر، ولا فاشيّة موسوليني، ولا هويّة الإمبراطورية العثمانية، ولا استبداديّة فرانكو، ولا اشتراكيّة روسيا، ولا.. ولا، بالتالي، فإنّ الأولى، وهي المحقّة بِرفض مختلف ما تقدّم، الممجّدة، والمقدّرة، لأنها دفعت كل هذه الأكْلاف في سبيل دفاعِها عن (تنويرِها)، أن لا تندفع، لا جماهيريًّا ولا فرديًّا، نحو فرض أيِّ منطقٍ، مهما تخيّلت صوابيّته، أو رأت أسبقيّته، على غيرِها.
كيف تكوّن الجمهور؟
في سياق دلالاتِها العادية، غير المركّبة نفسيًا، ولا المعبّأة أجنداتيًّا، فإن مُفردة الجمهور تعني "تجمعًا لمجموعة، لا على التعيين، من الأفراد، أيًّا تكُن هويّتهم القومية، أو مهنتهم، أو جنسهم، وأيًّا تكُن المصادفة التي جمعتهم" (لوبون، السيكولوجيا، ص 53).
وفي البعد الاصطلاحي، ومن وجهة النظر النفسية، وليس اللغوية، تتبنّى الكتلة الجماهيرية "مواقف قد لا تعبّر عن كلٍّ واحد من هذه الكتلة منفردًا. ومن المرجح أن تشكّل كتلةٌ بشريةٌ ما، خصائص جديدة، مختلفة، تمامًا، عن خصائص كلّ فرد من أفراد هذه الكتلة على حِدَة".
وفي الأصل، تراكمت فكرة تعريف الجمهور في سياق وصف الناس الذين يُقبلون على عرضٍ دراميٍّ، أو أيّ استعراضٍ عام يستقطب عددًا من الناس، ويتّصفُ ما أصبح يُعرف بِالجمهور منذ الزّمن اليونانيّ والإغريقيّ، ومن بعدهما الرومانيّ، بِسماتٍ عامّة، تراكمت على مدى الأزمان، وأفرادُه معروفونَ بِذواتهم، ومحدّدون في الزّمان والمكان. وهم، عادة، سكّان مدينة، أو قرية واحدة، يجتمعون بين الفيْنة والأُخرى، وعلى اختلافِ الظروف والمناسبات، ليتحوّلوا إلى جمهورِ عبادةٍ في مكان العبادة، وإلى جمهور في المسرح، أو في السوق، ولاحقًا، إلى جمهورٍ في الملعب. وكان الانضمام إلى هذا الجمهور يَجري، بحكم العادة، وفقًا لِلمراتب والمراكز الاجتماعية، وتشرف عليه سلطة دينية، أو روحية، أو إدارية، حيث كان يجلس الملك، أو سيّد القبيلة (في المجتمعات القَبَلية) في المقدمة، ثم تأتي حاشيته، ثم النبلاء والأعيان وكبار القوم، ويأتي عامّة الناس من بعدِ كل هؤلاء. وقد أضفت السلطات، في كلِّ زمان ومكان، على الجمهور طابعًا مؤسسيًّا توحّده سلوكياتٌ جماعيةٌ معيّنة، فالحاكم يحتاج إلى محكومين، ودُور العبادة تحتاج إلى عابِدين، والسوق تحتاج إلى مُشترين، والملعب لا يحتاج إلى لاعبين فقط، ولا إلى حكّام فقط، ولا إلى نشيديْن وطنييْن فقط، ولا إلى أعلام ورايات فقط، ولا إلى مسوّقين فقط، ولا إلى قوانين واتحادات فقط، ولكنه يحتاج، قبل كل هذا وذاك، وخلاله، وبعده، إلى جمهور.
على مرّ السنين والقرون، وتبدّل الحضارات، تطوّر مفهوم الجمهور، وأسهم اختراع الطباعة في القرن الخامس عشر الميلادي، على يد الألماني يوهان غوتنبرغ (1398 ـ 1468)، بِظهور نوعٍ آخر من الجمهور (جمهور القراءة). ومع صدور الصحف، صار يمكن الحديث عن "رأيٍ عام" يمكن توجيهه، أو استنباط توجهاته، أو مراقبة تحرّكاته. ليس هذا فقط، بل بات في مقدورِ السلطة الحاكمة التمييز بين نوعيْن كبيريْن يقعان ضمن نطاق سلطاتها: الخاصّة والعامّة، النُّخبة والعَوام، البرْجوازية المتسلّقة والبُروليتاريا الكادِحة، على اختلاف المسمّيات ومرجعيات هذه المسمّيات.
بعد الطباعة، جاء الدور على الإذاعة، ومن بعدها التلفزيون، وبينهما السينما، في نقلِ الجمهور من محليّة بقعتِهِ الجغرافيّة، إلى عالميّةِ تجمهرِهِ حول قيمةٍ، أو فكرةٍ، أو ماركةٍ، أو نادٍ، أو نجمٍ، أو زعيمٍ، أو استقطابٍ دينيٍّ، أو عنصريٍّ، أو إثنيٍّ، أو أيّ دافعٍ شعبويّ.
الفضاءُ الأزرقُ الذي تجلّى بوصفِه ذروةَ ثورةِ الاتّصالات، وَتكنولوجيا المعلومات، فاقَ كلّ ما سبقه، عند الحديثِ عن فرصِ الاستقطابِ، وممكناتِ جمعِ الأشتاتِ حولَ ما يجمعهم، وباتت مواقعُ التواصل الاجتماعيّ أخطرَ وسائلِ تحشيدِ الجَماهير، وأسهلَ من يُشيع (البروباغندا)، ويروّع الحقيقة، ويطوّع العقول، ويضلّل البوصلات.
حتمًا، لن تفي العُجالةُ أعلاه بتدبيجِ إجابةٍ شافيةٍ عن السؤال أعلاه: كيف تكوّن الجمهور؟ ولكنها قد تسهم في التأسيسِ لتصوّر ممكنٍ حول كاريزماتِ بناءِ جمهورٍ ما، وحول كيف كيّفت السُّلطةُ مَن حوْلها، وَجعلت من الكُتل المتشرذمةِ في مناطقِ نفوذِها قيمةً مضافةً لها، لا ضدّها.
كان لا بدّ، إذًا، من تَكوِّن الجمهور. كان لا بدّ من صيحات تشجيع، أو استهجان، أو تأييد، أو تراتيل عِبادة. كان لا بدّ من واضِعي (لايكات)، أو مروّجي إشاعات، أو مبتكري هُتافات. هل الجمهور، بِالتالي، جميعُه، بِجميع مكوّناته، وعلى اختلافِ تفاصيلِه المعرفيّة والخَلْقية والخُلُقيّة، يحمل الأبواقَ ويزمّر، أو يحمل الطبول ويطبّل؟ ليس شرطًا، فحتّى الثورات الصالحة تحتاجُ إلى جمهور، والأفكارُ النيّرة تحتاجُ إلى جمهور، والوعيُّ الجمعيُّ يحتاجُ إلى جمهور. كتلٌ لا بدّ منها، ولكن، وَيا لِحسرتي، ما أسرعَ استقطابَها، وما أهشّ وعيهَا، وما أقسى انقضاضَها حينما، بوحشيةٍ قطيعيةٍ مسلوبةَ التعقّل، تنقضُ لا تعرفُ لماذا، ولا كيف، ولا تعدّ للعَشرة، ولدينا، هُنا، في قصة قتلِ المدرّسة الأفغانيةِ فرخندة ملكيزاده الحاصلةِ على درجةٍ أكاديميةٍ في علوم الشريعة، المرتديةِ للحجاب، أسوأ مثالٍ على القطيعيةِ العمياء.
| "في البعد الاصطلاحي، ومن وجهة النظر النفسية، وليس اللغوية، تتبنّى الكتلة الجماهيرية "مواقف قد لا تعبّر عن كلٍّ واحد من هذه الكتلة منفردًا" |
الحشود التي تحوّلت إلى جمهورٍ مسيّرٍ مُنقاد قتلت فرخنده (27 عامًا) بِطريقةٍ بشِعة يصعب تخيّلها، أو حتى الخوض في تفاصيلها، من دون أن يتحقق الذين شاركوا في عملية القتل الجماعيّ الهائج من التهمة التي وجّهها لها (مُلّا) يتاجِر بالدّين. والقصة أن الشابّة المتديّنة كانت حاجَجت مسترزقًا باسم الدين يبيع السّحر لأحد المساجد في كابول، وأخبرته أن ما يفعله لا علاقة له بِالدين، لا من قريب ولا من بعيد، فما كان منه، وَقد أُسقط في يده أمام قوّة حجّتها، وَسلامة منطقها، إلا أن اتّهمها أنها (دنّست) القرآن وأحرقته، ورغم أنها أجابته وقالت له: "أنا مسلمةٌ، والمسلمون لا يحرقون القرآن"، ولكن هيهات، فقد فات الأوان، ووقعَ فأسُ الغوغاءِ والجهلِ في رأسِ العقل، وخلال دقائق معدودة، تدرّج الاعتداءُ الأعمى، من الركل والرفس والضرب بالخشب والحديد، والرجم بالحجارة، وصولًا إلى السحل بواسطة سيارة لِمسافة 300 متر، ثم إحراق الجسد، وفي تلك المرحلة بدأ (الجمهور) التبرّع بملابسه لِتبقى نارُ حرقِها متّقدة، فملابِسها كانت غارقةً بِالدم، ولا تُعين النارَ في عملِها!
مقابل هذا المشهد المروّع، مما لا شكّ فيه، أن النيوزلنديّ الذي (تسلّى) بقتلِ أكثر من 50 مسلمًا وهم ركّعًا سُجود، وجرح برشاشه الأوتوماتيكيّ، تقريبًا، مثلَهم، يجسّد غوغائية جمهورٍ من نوعٍ آخر. جمهورُ برينتون تارانت (اسم الإرهابيّ الذي ارتكب جريمة نيوزيلندا)، كان يتابعه بلهفةٍ وحماسةٍ على الهواء مباشرةً! (تارانت كان يضع كاميرا عند فوّهة البندقية)، وحظيَ بتأييدٍ لعلّ الشعبويّ ترامب لم ينل مثله! صحيحٌ أن الاستنكار كان كاسحًا، ولكن الخشية، كلّ الخشية، هي ممّن يستنكرون بِألسنتهم، ويؤيدون بِأعماق الكراهية المزروعة، كالطّاعون، في ضلوع تكوّنهم الجمعيّ الذي تراكمت مفرداته على مرّ عصورٍ سحيقةٍ من بثّ الضغينة، وتجييشِ الحُشود، وغسلِ عقول الأتْباع، وترويضِ العامّة (العَوام). أليس العَوام المطلوبين لِعدالة المحاكم، هم من أرسلهم الغرب إبّان الحملات الصليبيةِ المدّعية أن حربَها مقدّسة، ورسالتَها محصّنة، تسعى لِإنصافِ العهديْن، القديم والجديد؟
على وجه العموم، فإن الانضواء في الحشدِ الجماهيريّ له مفعولُ التنويمِ المغناطسييّ، المُفضي إلى تصرّفات، وردودِ أفعالٍ، وأشكالِ تلقٍ غيرَ واعِيَة. وها هو لوبون يقول: "الجماهيرُ غيْر ميّالة، عادةً، للتأمّل، وغيْر مؤهّلة لِلمحاكمة العقليّة" (صفحة 45).
يبْدو أنّ الفردَ المُنضوي بيْن الجمهور يتولّد لديهِ شعورٌ بِالقوة، ما يجْعل اندفاعَه نحوَ بعضِ الأفعالِ الغرائزيّةِ ممكنًا. هذا الاندفاع، أو الانصياع، كما يسمّيه لوبون، يحدُث، في كثيرٍ من الأحيان، بشكلٍ اختياريّ، بقوّة التّباهي النّاجمة عن قوّةِ الحَشْد، وفي ظلِّ غيابِ الإحْساس بالمسؤوليّةِ الفرديّةِ التي تَغيب، تمامًا، بِفعل ضغط الكُتلة (الجماهيرية) ومُغْرياتها. وممّا لا شكّ فيه أن العَدوى العقليّة مِن جِهة، والتّحريض من جهةٍ أُخرى، يلْعبان دورًا محوريّا في ظهورِ الصّفات الجماهيرية العامة.
كلُّ هذا يقودُنا إلى ما يمْكن تسميتَه: "عِلْمُ نَفْسِ القَطيع"، حيث غِياب الفِعل الواعي، وتسيّد الانْخراط المسيّر غيرِ المُدْرِك، وَلا المَسْؤول (القطيعيّ بشكلٍ، أوْ بِآخر).
هذا ما يتلقّاه الجمهور، ولكن، كيف يتحقّق هذا التلقّي؟ وهل هو واحدٌ في مختلفِ الحالات؟ وما هي العوامل التي تؤثّر في شكل التلقّي وَمحتواه؟ وفي مردودِه وطرائقِ التّعبير عنه؟
مساراتُ التلقّي
التلقّي ليس مفردةً حديثةُ العهد، فها هو القرآن يقول للنبيّ محمد: {وإنك لَتُلقّى القُرآنَ مِنْ لَدُن حَكيمٍ عَليم} (سورة النمل، آية: 6). وَفي آيةٍ أُخرى: {فتلقّى آدَمُ مِنْ ربِّهِ كلماتٍ فَتابَ عليه، إنّه هُوَ التوّاب الرَّحيم} (سورة البقرة، آية: 37).
على وجه العموم، فإن معنى التلقّي في مداه اللغوي، وكما ورد عند ابن منظور في "لسان العرب"، أي تلقّاه/ استقبله، وفُلانٌ يتلقّى فُلانًا، أيْ يستقبلُه.
والتلقّي، اصطلاحًا، هو "الفعل الذي يمارسه الفردُ كإنسانٍ لهُ مكوناتهُ النفسيّةِ والذهنيّةِ والانفعاليّةِ والاجتماعيّةِ، لِتفسيرِ ما يُقدَّم له. وهو فعلٌ يتضمّن: الإحساسَ والذكاءَ والإدراكَ وبناءَ المعنى" (مخلوف بوكروح، 2006).
وهُو "الاتّجاهاتُ والنّشاطاتُ التي يُظهرها المتلقّي خلال تلقّيه لِرسائل الأعمالِ الأدبيّةِ والفنيّةِ والإعلاميّة. كما يمثّل، أيضًا، الطريقة، أو الأسْلوب الذي يسْتخدم فيه المتلقّي المعلوماتِ التي يتلقّاها من الخطاب مهما كانت طبيعته" (نظرية التلقي وأطروحاته، د. مرزوق الشريف، مجلّة النص، المجلد السابع، العدد الأول، صفحة 194، سنة 2021).
| "الفردَ المُنضوي بيْن الجمهور يتولّد لديهِ شعورٌ بِالقوة، ما يجْعل اندفاعَه نحوَ بعضِ الأفعالِ الغرائزيّةِ ممكنًا" |
مع تطوّر العلومِ الإنسانيّة، صار لِلتلقّي نظريات، وآفاق توقّع، خاضَ فيه الباحِثون والدّارسون، وطلاب الدّرجات الأكاديمية، استقصاءً ونبشًا وتعريجًا على أهمِّ المنظّرين فيه. وَمنذ أعلن الفرنسي رولان بارت (1915 ـ 1980) "موت المؤلِّف"، باتت معظم نظريات النقد الأدبي وطروحاته تتجّه نحو المتلقّي. وَنظرية التلقّي مرتبطةٌ، كما بات معلومًا لدى أصحاب الاختصاص، بمرحلة ما بعد الحداثة، أي عندما نزَعت أوروبا نحوَ نقدِ مركزيةِ الذّات. وهي، إلى ذلك، تمثّل "النموذج الجديد الذي يمكن الاستئناسُ به في قراءةِ الأعمال الأدبيّة والفنيّة"، كما يرى الناقد الألماني هانس روبرت جاوس أو هاوس (1921 ـ 1997) في بحثه الذي يحمل عنوان "التغيّر في نموذج الثقافة الأدبيّة". وجاوس، ابْن جامعة كونستانسن الألمانية، هُوَ أحد المنظّرين الروّاد لنظريةِ التلقّي.
لا شك في أن مؤثراتٍ ومحدّدات عديدة (جوّانيّة وبرّانيّة) تلعب دورًا مهمًّا في شكلِ التلقّي، ودرجاتِه، ومردودِه، وَخيارات التفاعل بعد فعل التلقّي. ومن هذه المحدّدات: قيمُ المتلقّي، وعيُه، معتقداتُه، ثقافتُه وسلّةُ معارفِه، محيطُه الجمعيّ، سياسات حكومته، مستواه الاجتماعيّ والاقتصاديّ، وَعوامل أُخرى كثيرة. كلُّ هذا يعيدُنا، مرّةً أُخرى، إلى معضلةِ الجمهور، وَلنا في قضايا تكفيرِ الكتّاب، وتخوينِ المُعارضين، وشيطنةِ المُختلفين، وبثّ الرعب من اللاجئين، وَلصقِ تهمةِ الإرهاب بالملوّنين، والتقْليلِ من شأنِ الآخرين، والاستهتارِ بثقافتِهم، وموروثِهم، ومرجعياتهم الأخلاقيّة والقيميّة، أدلّةٌ دامغةٌ، على انْجرافِ كثيرٍ من ميكانيزْمات التلقّي نحو ردِّ الفعل الجماعيّ المروّض. إن تنميطَ التلقّي غايةٌ كبرى تسعى السُّلطة لِتكريسِها. والسّلطةُ، هُنا، قد تكون دينيةً، أو سياسيةً، أو اقتصاديةً، أو حلفًا عسكريًّا، أو عِرقًا أبيضَ.
آفاق الدائرة
التلقّي جزءٌ من دائرةٍ تتكوّن من: مرسِل، رسالة، متلقٍّ، إضافةٍ إلى رسالةِ ما بعد التلقّي (الرسالة الثانية، باعتبار أن رِسالة المرسِل هي الرسالة الأولى). والآفاق التي تهمّنا من بين باقي زوايا هذا المعين، أو أقطاب هذه الدائرة، هي آفاق الرسالة الثانية، فهي خلاصة كلّ هذا المعادلة الرُباعية المدوّرة. إنها التغذيةُ الراجعةُ التي يَنشدها صاحب الرسالة الأولى. وهي ما تجلس أركان السلطة بِعيونٍ متيقّظةٍ، وآذانٍ مشنّفة، لتتابع، على مدار الساعة، المردودَ من وراءِ بثّ الرسائل التي تودّ من متلقّيها أن يتلقّوها، من دون سِواها، حتى لَتكاد، لو كان ذلك في استطاعتِها، أن تُغلق على رعاياها (جمهورها المفترض وفضاؤُها العام) كل فتحات تسريبِ أي رسائل أخرى غير رسائلها. تود لو تقفل النوافذ، وتخنق كلَّ هواءٍ غير هوائها. فكيف لها أن تروّض الرأي العام، من دون كل هذه الإغلاقات، ومن دون أن تكون قادرة على تحديد ما تسمح له بالمرور، وما تمنعه الاقتراب من فضاء سلطتها؟
(ولن أمنع نفسي، هنا، من الاستشهاد بقصة أن منبر "ضفة ثالثة"، على سبيل المثال، غير متاح في بعض الدول العربية، كثير من الأصدقاء يهاتِفونني مستنجدِين: لم نستطِع فتح رابط الموضوع الذي أكون، مثلًا، قد اقتبستُ منهم خلال كتابتِه، أو طلبتُ رأيهم فيه).
هل يبقى للدائرة المتخيّلة تلك من آفاق، بعد كل هذا الانغلاق؟ ولكن، صدّقوني، هو ليس انغلاقًا شرقيًّا بحتًا. هل فتح الغرب ملف (الهولوكوست)؟ هل يسمح بمجرّد التطرّق إليه؟ أين هم الآن كل الذين حاولوا إعادة تأمّل المحرقة بعد 79 عامًا من حدوثها؟ هل يقبل الغرب إيّاه أيَّ مراجعةٍ علميةٍ نقديةٍ موضوعيةٍ لِهذه الاندفاعةِ الغريبةِ والعَجيبة نحوَ تأييدِ شريحةٍ من دون سِواها، من بيْن باقي كلِّ شرائحِ المُجتمع؟ وأنتم، حتمًا، تعرفون أيَّ شريحةٍ أقصد، تلك التي أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، لمجرّد أن قطر طلبت تأجيل فَجاجتها لِعيون شهرِ رياضةٍ ومحبّةٍ فقط!
لا أحد يريد استهدافَ اختلافاتِ البَشر، ولكن من قال إن من حق المختلفين أن يفرضوا علينا (نحن الأسوياء) أن ننحني لهم عند كل ناصية طريق، خضوعًا لِماكينة إعلام لا تهدأ، وَحملة ضَروس تتضمّن مسلسلات، وأفلامًا (مئات الأفلام صدّقوني فأنا أشاهد فيلميْن يوميًّا على الأقل)، وبرامج، ومنشورات، وملصقات، ومشاريعَ مدْعومة، ورواياتٍ ملْغومة، واستدامةً مزعومة، وألوانًا، وخِططَ عَمَل، وتِكرارًا لا يهدأُ ولا يَمَل؟
"لكم دينكم وليَ دين". وليس من العدل، ولا من المنطق، أنكم تريدونَنا، رغْم أنوفِنا، أن نعبدَ ما تعْبُدون؟
معضلةُ الشّرق
شكّل الشرق منذ أوّل الزمان، وما يزال، حالة عصيًّة على الغرب.
يقول البروفيسور كريج كلوناس، أمين متحف فرويد في لندن، والخبير في الثقافة الصينية، إن الشرق بالنسبة إلى سيغموند فرويد (1856 ـ 1939) ظل يماثل منطقةً مظلمةً وخفيةً في لاوَعيِه، معلّلًا بِكلامه هذا سبب احتفاظ مؤسِّس مدرسة التحليل النفسي، وصاحب نظرية العقل الباطن، بِقطعة أثاثٍ صينية (شاشة صغيرة مصنوعة من اليشْم والخشب المثقوب)، وطلبِهِ من صديقتِهِ ماري بونابرت تهريبها إليه، من دون كل باقي أثاث منزله، عندما فرّ من النازيين إلى لندن، وأراد أن تكون تلك القطعة رفيقة أخريات أيامه، بعيدًا عن وطنه النمسا.
إن حال فرويد هي حال ملايين الأوروبيين، بمن فيهم مئات المستشرقين، الذين قضى بعضهُم أعمارَهم مُحاولين فكّ طلاسم الشرق، فإذا بهم، وفي فوْرةِ استعصائِهِ عليهم، ينصحون باستعمارِه، فهذا فعلٌ أسهلُ من محاولةِ فهم الآخَر وتقبّله!
تقبّلونا بِما نَحْنُ عليه، يرحمكم الله، قبل أنْ تفرِضوا عليْنا تقبّلَكم على علّاتكم.
