



محمد الديهاجي
عبد اللطيف الوراري: أتبنى مفهوم الحساسية في مقاربة التجربة الشعرية الجديدة
1 - أبريل - 2020م
عبد اللطيف الوراري شاعر وناقد مغربي، عضو بيت الشعر في المغرب، يبحث في قضايا الشعرية العربية قديمها وحديثها. له كتب عديدة في الشعر والنقد، من ضمنها؛ في الشعر: «لماذا أشْهَدْتِ عَليَّ وعــد السحاب؟» دار أبي رقراق- الرباط 2005؛ «ما يُشْبه ناياً على آثارها» (جائزة الاستحقاق من جوائز ناجي نعمان الأدبية 2007)؛ «تريــاق» (جائزة الديوان الشعرية- برلين)، منشورات شرق غرب- بيروت- 2009؛ و«ذاكرة ليوم آخر»، دار التوحيدي- الرباط، 2013. صدر له في النقد: «تحوُّلات المعنى في الشعر العربي» (الجائزة الأولى في النقد من جوائز الشارقة للإبداع العربي)، دائرة الثقافة والإعلام- الشارقة- 2009؛ «نقد الإيقاع: في مفهوم الإيقاع وتعبيراته الجمالية وآليّات تلقّيه عند العرب»، دار أبي رقراق- الرباط، 2011؛ «الشعر والنثر في التراث البلاغي والنقدي»، سلسلة كتاب المجلة العربية- الرياض، 2013؛ «في راهن الشعر المغربي.. من الجيل إلى الحساسية»، دار التوحيدي- الرباط 2014. وله في السيرة الإبداعية: «قصّتي مع الشعر» (نسخة رقمية)، شركة الارتقاء المعرفي- الرياض، 2013. كما ساهم في كتب نقدية مشتركة من ضمنها: «علي جعفر العلاق: الصوت المختلف» (عمان، 2013)؛ «الأوتوبيوغرافي في الشعر المغربي المعاصر» (الدار البيضاء، 2014).
نص الحوار:
■ كما هو في علمك، تغدو القصــيدة عند كل شاعر، بعد أن تنضج تجربته الشعرية، وتتخطى مرحلة الكتابة الحدوسية أو العفوية، أقول تغدو مشروعا يعكس تصور الشاعر للكتابة ومدى وعيه بها. فكيف تنظر للكتابة الشعرية كأفق في مشروعك الشعري؟
□ كنتُ مشدوداً، منذ بدايات قصيدتي الأولى، إلى ميلٍ في الإطالة والتثقيف والتنقيح، بزعمي أنّ القصيدة هي طول النّفَس، وأنّ الشعر صنعةٌ وفنٌّ. وهذا الفهم للقصيدة تأتّى لي من قرءاتي لتاريخ الشعر والشعرية عند العرب، وسعيتُ إلى تجسيده بصيغ وأشكال متنوّعة تتطوّر مع تحولات التجربة، بدون أن تنزاح عن جوهر ذلك الفهم. في ديواني الأوّل «لماذا أشهدت عليّ وعد السحاب؟»، والدواوين الثلاثة التالية: «ما يُشبه ناياً على آثارها» (2005)، و«ترياق» (2009)، أحاول قدر الإمكان أن أطوّر تجربتي، بدءاً من الغنائية التي أعمل عليها باستمرار بجذريْها العاطفي والرمزي، وانتهاءً برفْد المتخيّل الذي يدفع بالذّات إلى أقصاها في مخاطبة المطلق، عبر وجوهٍ وحيواتٍ وعوالم متعدّدة، بهذا الشكل أو ذاك. فلا يعنيني في الأشكال التي اُكبّ عليها بقدر عنايتي بإيقاع الذات والعمل عليه، داخل البناء النصّي، الذي ترفده موسيقى هامسة من الإيقاع، ويسهم فيه تنويع التراكيب، مثلما عنايتي بالتصوير الشعري وإدارته في إطار من الحوار الخارجي، الذي يستبطن الحالات الشعرية المختلفة، وهي تشفّ عن ذاتيّتي وشرطها الثقافي والوجودي. مع ديواني «ذاكرةٌ ليوم آخر» (2013)، عانيتُ من مرحلة عبور نفسي وجمالي من الطور السابق إلى طور آخر أكثر جدّةً وتنويعاً على همومي الشخصية. وقد عكست قصيدة «تقاليب ضوء» المكوّنة من مقاطع شذرية متراكبة، هذه الروح العبورية بامتياز. وهكذا، فإنّي اليوم أكتب شعراً مختلفاً، شعراً مائلاً إلى القصر، مقطعيّاً، متشظّياً وشذريّاً أُضمّنه أمشاجاً من حياتي المتخيّلة أكثر منها الحقيقية، انسجاماً مع تصوُّري للذات والزمن والكون. وفي نظري، أرى أن الوقت حان للقطع مع القصائد الطوال ذات البناء الغنائي أو الدرامي الشاهق، التي لا تتوافق مع طبيعة حوامل الكتابة الجديدة، إنتاجاً وتلقّياً؛ فالمُعوَّل عليه ـ هنا – هو الكتابة الشذرية أو الإبيغرامية التي سنحت لها اليوم سانحة ثمينة، لكي تنقل الشعر إلى عهد جديد، وتلقٍّ جديد، ومقولات جديدة.
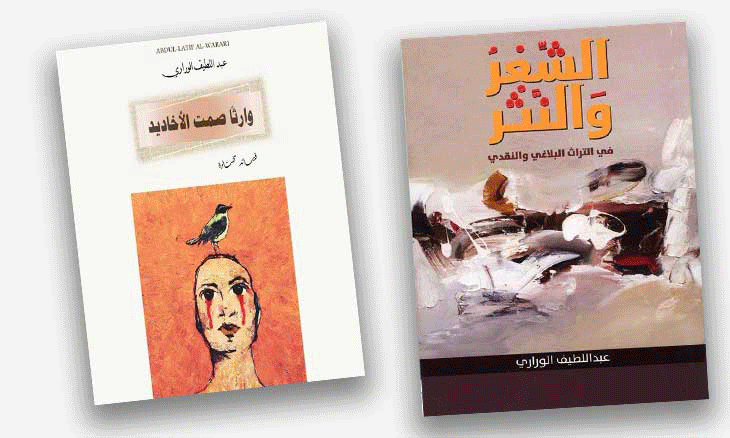

■
■ يعيــــش المشهد الشـــعري المغربي اليوم، وضعا مشوبا بالالتباس بالنظر إلى الرواج الحاصل على مستوى الإصدارات والنشر الورقي والإلكتروني، بدون اعتبار، في أحايين كثيرة، للقيمة الفنية لما يكتب ، من جهة، ومن جهة أخرى نسجل توترا ملحوظا في العلاقة بين الشعراء وجمهور الشعر. ما تقييمكم لهذا الوضع؟
– إذا طالعنا نصوص التجربة الشعرية التي انخرط في كتابتها الشعراء، ابتداءً من أواسط التسعينيّات وعبر بدايات الألفية الجديدة، جاز لنا أن نستقرئ السمات الشعرية الأساسية التي ترتدّ إليها، ومن ثمّة وقفنا على حجم المغامرة التي ارتادوها بما تنطوي عليه من رهانٍ على الاختلاف والتعدُّد؛ فهم لا يكتبون بسويّةٍ واحدة، ولا يجمع بينهم فهْمٌ محدّدٌ للعمل الشعري، أو هم يشتركون في هذه الخصيصة، أو تلك، ويتنازعون هذا البعد وذاك. كما أنّ مصادر كتاباتهم تعدّدت جغرافيّتها، لتشمل كثيراً من آثار الشعر العالمي بلغته الأصلية أو مترجماً. ولا شك في أنّ ذلك ممّا يُغني الشعر المغربي المعاصر، ويصنع حيويّته، بالقدر الذي يعكس من خلاله صراعاً ضمنيّاً بين جماليّاتٍ متعارضة في كتابة القصيدة، وطرائق مختلفة لبناء الذوات ورؤاها إلى العالم.
■ ليس من شك فـــي أن ما يمــــيز هـــذا المشــهد اليوم، كما تفضلت، هو التعدد والاختلاف، وهذا معطى صحي وإيجابي بالنظر إلى حق كل شاعر في الاختلاف الشــعري، بمبرر اختلاف الحساسيات. فما هي أبعاد ودلالات هذا المفهوم (الحساسية) عندك؟
□ في قراءتي للشعر المغربي المعاصر، أتبنّى مفهوم الحساسية، وأتوسّل به كأداة إجرائية في مقاربة التجربة الشعرية الجديدة، باعتبار أنّ الحساسية، هنا، نتاج سياق سوسيوثقافي ضاغط، تستجيب لمؤثّراته وتتفاعل معه باستمرار؛ ومن ثمّة يتركز تحليل مفهوم الحساسية على بيان أثر الإبدالات الجمالية، التي طالت فضاء القصيدة الحديثة، أو تلك التي اعترت المادة الشعرية في نصوص التجربة الجديدة. وبما أن الحساسية الجديدة ممتدّ في الزمن، فإنّ استعمال مفهومها وتصوُّرنا لها لن يكونا ذا دلالة، إلا عندما تكون مدة سريان التغير ممتدّة في الزمن، هنا والآن. وهي، من هنا، أبعد من أن تكون تعبيراً عن الموجة الجديدة التي يلحقها بعضهم بـ(الموضة)، ويكرّسها قدحاً أثناء حديثه عن التجربة الشعرية الجديدة. لقد أبان عدد غير يسير من شعراء التجربة الموهوبين، من خلال اجتهاداتهم واقتراحاتهم النصية، عن وعيهم باشتراطات الحساسية الجديدة، فانحازوا إلى شعريّتها المختلفة التي تقوم على تنوّع الرؤى وتمايزها، بنسب محدّدة، عمّا سبقها، وتكشف عن تحوُّل في الحسّ الجمالي، وفي مفهوم الذات والنظر إلى العالم، وفي تقنيات التعبير الفني للقصيدة خاصة، وللكتابة عامّة. وهكذا، فإنّ الارتباط بعامل الزمن لا يعني لنا من قيمة إلّا بمدى قيمة الأشخاص المتحرّكين داخله، ودرجة حضورهم فيه. وإذ أتحدّث عن حساسية جديدة في الشعر، فإنّما أريد التوكيد على قيمة التحديث والمغايرة والاختلاف التي صاحبتها وتبنّتْها، بدلاً من حساسية قديمة كانت ترهن الشعري بالأيديولوجي والرسالي في زمنٍ ما وحقبةٍ ولّتْ. أمّا هذه الحساسية الجديدة فهي ليس حساسية واحدة ومنسجمة، وإنّما هي بالفعل حساسيّاتٌ متعددة وغير منسجمة، قياساً إلى أنّ رؤاها ومرجعيّاتها وروافدها وطرائق تدبُّرها للكون الشعري وبنائه مختلفة إلى حدّ التعارض، وأنّ شعراءها لا ينضوون في جيل، ومدرسة وتيّار ما. إنّهم منذورون لذوات لا تُحلّق إلا لتُخفق، وأيادٍ لا تكتب إلا لتمحو. ويحقُّ لنا، بعد هذه السنوات القليلة، لكن المؤثرة، أن نتكلّم عن شعرية مغربية جديدة بما للزمن من استحقاقاتٍ، تأتي عبر ما تراكم في مجال النّوع الشعري والإضافات التي يشهدها الشعر المغربي بوصفه «شعر أفراد وليس شعر أجيال».
■ بالعودة إلى تجربتـــكم الشعـــرية، فـــي أي حساســـية يمكن إدراج تجـــربة عبد اللطيف الوراري؟
□ أعتقد أن تجربتي الشعرية تنخرط في هذه الحساسية بجُمّاع ما فيها من مقترحات وأشكال صياغة ورؤى جديدة للذات وللعالم. ولقد تحدّثتُ عن هذا في نص شهادتي عن «التجربة الشعرية الجديدة في المغرب» التي احتفى بها بيت الشعر المغربي، يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2009 في الدارالبيضاء، عندما قلتُ إنّها: «تجربة تتنامى في عبورها الخاص، وفي انتباهها الخاص، منحازةً أكثر إلى كتابة تشفُّ عن ذاتٍ تعاني عزلتها، وتواجه هشاشتها، فيما هي تطفح بالحب والغناء والأمل في إعادة صياغة الحياة والتحرُّر من القيود.
